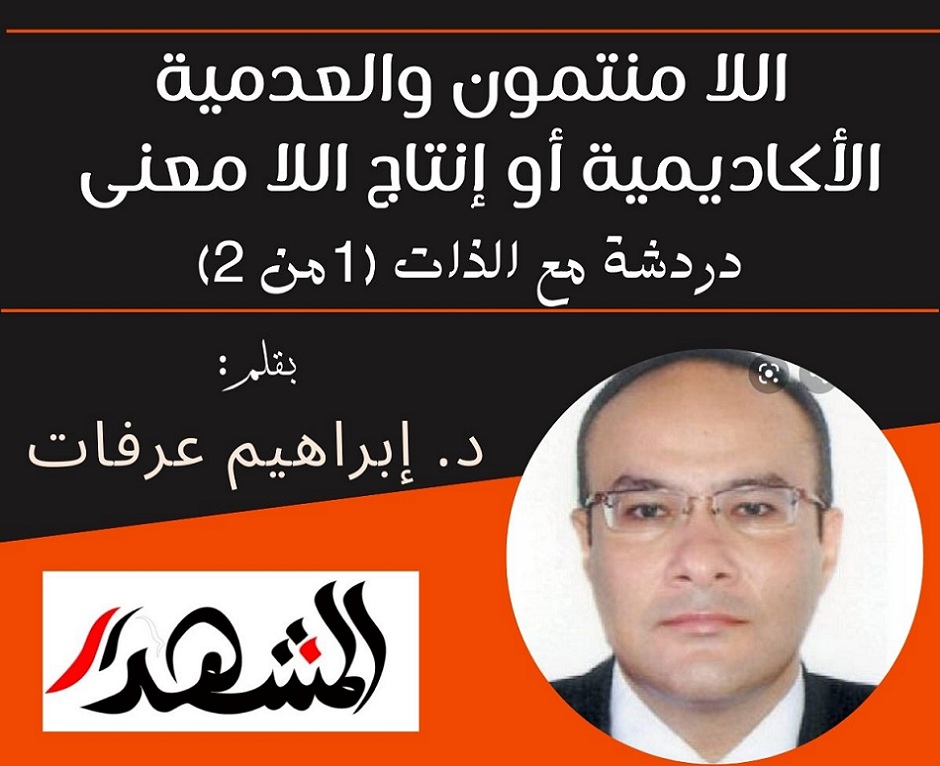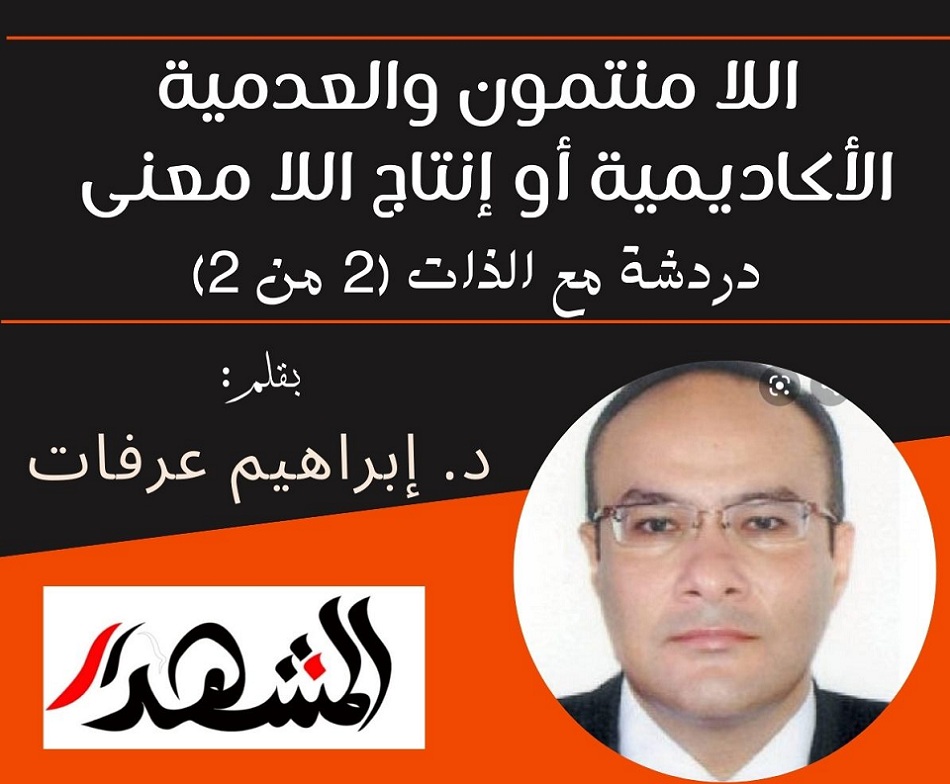العلوم الاجتماعية بين حاء وهاء
بعد دردشة مطولة مع الذات رأيت أن أكتب هذه الورقة لكي أعرض من خلالها لواحدة من أسوأ أزمات العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. وما أكثر تلك الأزمات وما أشدها تعقيداً. بعض منها بنيوي عميق يعود ربما إلى قرنين من الزمان. وبعضها الآخر إجرائي معقد يزعج المشتغلين بتلك العلوم تقريباً كل يوم. وبعض ثالث منها سلوكي غريب يلاحظه الواحد منا حتى في نفسه.
والأزمة التي أركز عليها بشعة، لأنها ثلاثية الأبعاد: بنيوية وإجرائية وسلوكية، تتلخص في أن عدداً ليس بقليل من كليات العلوم الاجتماعية العربية لم يعد ينتج معنىً يرتقي إلى ما يفترضه العلم الاجتماعي، أو يشبع ما يحتاجه المجتمع، أو يقدم ما كان مؤسسوها يأملون في الأصل منها عندما أنشئت، أو بات ينتج ما يسميه المصريون مزاحاً "بالهلاضيم" أو بتعبير التونسي الرائع الطاهر لبيب الرئيس السابق للجمعية الدولية لعلم الاجتماع "اللا معنى". هذه المعاهد والمؤسسات لم تعد في تقديري قادرة على إنتاج المعنى، بل وتسرف في إنتاج اللا معنى، إلا لأنها تحتضن طوابير من اللا منتمين الذين لا يلتزمون بأصول ومرجعيات وضوابط وشروط ممارسة تلك العلوم. ولعلنا نتفق من البداية على بدهية بسيطة تقضي بأنه لا مجال لعلوم اجتماعية نافعة بدون مشتغلين نافعين.
ومشكلتا اللا معنى واللا انتماء مرتبطتان، ويشكلان معاً أزمة بنيوية وإجرائية وسلوكية عويصة تعصف بدور وبتطور العلوم الاجتماعية العربية. هي أزمة بنيوية لأن نشأة عدد ليس قليل من كليات العلوم الاجتماعية في البلدان العربية جاء إما مشوهاً، أو مبتسرًا، أو فوقياً، لم يراع قواعد البناء والنضج السليمة للمؤسسات. وهي أزمة إجرائية لأن ما يجري كل يوم في تلك الكليات يكشف عن أنها تكبل نفسها بإجراءات ونظم تشغيل ولوائح إدارية تنحرف بها عن مقاصدها ليصبح الشكل فيها أهم من المضمون وبقاء الأشخاص أعلى من مصلحة المؤسسة ذاتها. وهي أخيراً أزمة سلوكية لها مظاهر لا يمكن أن تخطئها العين، وهي ترى تصرفات منفرة يأتي بها بعض المشتغلين بالعلوم الاجتماعية، أقل ما يقال في وصفها أنها مجافية للصواب إن لم تكن مخجلة ومعيبة.
ولا أزمات بدون مسببات. وأبرز مسببات تغييب المعنى عن العلوم الاجتماعية يتصل بتغييب اللا منتمين، وهم جزء من المشتغلين في أروقة مؤسسات العلوم الاجتماعية، لا أحب ولا أريد أن أحدد حجمه، لكنهم بوضوح راحوا يعمقون سقطات العلوم الاجتماعية العربية، بدلاً من أن يقيلوها من عثراتها. قليل منهم، وإن كانوا مؤثرين أتوا من أراض بعيدة، لكن أغلبهم نبت وترعرع في قلب هذه المنطقة. وعليّ أن أشدد مرةً أخرى أنه لا مجال لعلوم اجتماعية نافعة بدون مشتغلين نافعين.
وليس من الانصاف أن أرمي أو يرمي أحد غيري بعبء تلك الأزمة كاملةً على عاتق اللا منتمين. فما الأزمة إلا جزء صغير من سياق عام أوسع، بالذات السياق السياسي العربي، الذي ما زال يخشى من العلوم الاجتماعية أكثر مما يخشى عليها، ويغضب منها ولا يكاد يغضب لأجلها. إن رآها تنتج كثيراً من المعنى انزعج. ولهذا فهو كثيراً ما يتركها تنتج اللا معنى حتى لا تزعجه، وحتى لا تلفت انتباه المجتمع إلى قيمة ورسالة ومعنى تلك العلوم.
وقد لمست أزمة اللا معنى واللا انتماء مراراً. لمستها لما سكنت لفترة أولى من حياتي المهنية ذلك البرج العاجي الشهير الذي يأوي إليه كثير من ممارسي العلوم الاجتماعية ليثرثروا وينظّروا ويتشدقوا ويتفاصحوا. ولمستها كذلك لما تسكعت مثل أي مشرد في دروب وأزقة بلدان عربية وأخرى أسيوية للاختلاط بالناس من أجل إتمام بعض البحوث الميدانية. ولمستها عن قرب أكثر ولمدة أطول من خلال تجربة ثرية عشتها قرابة ربع قرن علمتني حقاً من أنا وما قيمتي وقيمة أي مشتغل بالعلم الاجتماعي، وذلك عندما كنت في تماس مباشر مع مؤسسة مسؤوليتها صنع القرار.
وقد عرّفتني الخبرات الثلاث: النظرية الغارقة في التجريد، والميدانية اللصيقة بالناس، والنخبوية القريبة من صنع القرار أن العلوم الاجتماعية العربية بشكل عام، وعلم السياسة الذي أنتمي إلى تقاليده بشكل خاص، علوم مقصرة. تطحن لكنها لا تنتج طحيناً، تحكي بلا أثر، وتتكلم كلاماً كبيراً ليس لأغلبه معنى. ولهذا فإن المشتغلين بها في حاجة ماسة إلى وقفات شجاعة مع أنفسهم لا يعلقون فيها عجزهم على شماعات الغير، وإنما يفكرون من خلالها في كيف يصححون ويغربلون مؤسساتهم بأنفسهم، وكيف يَرتِقون ثيابهم المهلهلة بأيديهم. والبداية بأن يسألوا أنفسهم سؤالاً صعباً لا مفر منه إن أريد لتلك المعاهد إصلاحاً: هل نحن حقاً ننتمي إلى تلك العلوم؟
دون تلك الوقفات ستبقى الأزمة قائمة، بل وستستفحل. فالأمر جد معيب حيث أدخلت ممارسات كثير من اللا منتمين العرب ممارسة العلوم الاجتماعية في المنطقة في دائرة مهولة من العدمية وقلة القيمة، ثم جاء بعض آخر من اللا منتمين ممن وفدوا من وراء البحار ليحكموا غلق الدائرة بالضبة والمفتاح. وأردد مرةً ثالثة أنه لا مجال لعلوم اجتماعية نافعة بدون مشتغلين نافعين، وإلا سيستمر تغييب المعنى كلما جرى تغليب اللا منتمين.
ولكي تتضح العلاقة بين اللا منتمين واللا معنى اسمحوا لي أن أشارككم لقطة رياضية ربما هي التي حفزتني على طريقة مقاربتي للموضوع. فقبل نحو ثلاثة أسابيع فاز فريق ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وفي غمرة الفرحة بتحقيق البطولة من بعد مباراة مثيرة التهم فيها ليفربول فريق توتنهام على ملعب الأنفيلد بنتيجة 5 أهداف لهدف واحد، تغنى أنصار ليفربول بأسماء لاعبي فريقهم منادين عليهم لكي يقتربوا منهم ليوجهوا لهم التحية. ولفت انتباهي مقطع طريف كشف لي عن ارتباط اللا انتماء باللا معنى. فقد سمعت مشجعاً ينادي على أحد اللاعبين بطريقة غريبة بدت وكأنها تستحث المسلمين على أداء عبادتهم اليومية الرئيسية. فقد كان يقول: "صلاه". وكان يطيل في نطق الهمزة ثم يضغط فجأة على حرف الهاء بما لا يقبل شكاً في مسامع أي مسلم في أنه كان يدعو لإقام الصلاة. لكن مشجعاً آخراً كان يقف بجواره راح ينادي بعامية مصرية لم تضلها أذني: " يا صلاح...يا محمد... يا محمد يا صلاح."
ضحكت على المشهد وسخرت من سوء ظني لأن ملعب الأنفيلد ليس مسجداً يقيم المسلمون الصلاة على أرضه، ولأن "صلاه" Prayer كما نطقها ذلك المشجع المتحمس لم تكن إلا محاولة للفت انتباه اللاعب "محمد صلاح". كان يقصد أن يقول "صلاح" تماماً مثلما نقولها نحن العرب بحاء واضحة، لكنه معذور لا يستطيع أن ينطق الحروف الصعبة في لغتنا، فهو لا ينتمي إلى الثقافة العربية ولا يعرف أصول اللغة العربية، وليس مطلوباً منه وهو يعيش حراً بلغته الإنجليزية على أرضه الإنجليزية أن يفهم خصوصياتنا أو ينطق كما ننطق. ولهذا أحل الهاء محل الحاء فجاء نداؤه بمدلول يخالف الدال الذي استعمله، وبمعنى يختلف عن مبنى الكلمة التي حاول أن ينطقها.
ولم يكن ذلك الفيديو إلا أقصوصة بسيطة أوحت لي بفكرة المداخلة التي تحاول رصد حالة الانفصام في العلوم الاجتماعية العربية بين الدال والمدلول، ذلك الانفصال الذي أنتج وما زال ينتج كثيراً من اللا معنى، وسببه الأهم في تقديري تلك الصفوف المتكاثرة من اللا منتمين الذين دخلوا تباعاً ولأسباب مختلفة إلى الصنعة. ولتكن البداية مع مسألة اللا معنى.
اللا معنى
فالمشتغلون بالعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية وبعد أكثر من قرنين من أول تعرف على تقاليدها المستوردة، وبالتحديد عندما دخل عبد الرحمن الجبرتي إلى قلب المجمع العلمي المصري الذي أسسه نابليون بونابرت في القاهرة في 20 أغسطس 1798 ما زالوا يعيشون حالة من الدهشة، إن لم تكن من الفوضى والاحباط. حالة انفصلت فيها الدوال عن الأحوال، والدالات عن المدلولات، والكلمات عن المعاني. وبتعبير مصري دارج أصبحت العلوم الاجتماعية العربية "مبتجمعش." لا تنتج معنى. تحكي كثيراً وتَحرُكُ كثيراً وتنفق كثيراً وتخرّج أعداداً غفيرة، لكن أغلب ما تنتجه قليل المعنى إن لم يكن بلا معنى. بات الدال فيها بكل أسف لا يعبر عن المدلول. تباعدا أحياناً عن بعضهما بدرجات مذهلة. واسمحوا لي بضرب مثل، بل اثنين. أولهما عن تجربة أكاديمية حية أعرفها. فعندما أسمع دالاً أو لفظاً يخبرني بوجود "برنامج لدراسات الشرق الأوسط" يفترض ذهني تلقائياً معان محددة. لكن عندما أفتش في المدلول لا أجد للفظ أي معنى، وأنه ليس إلا مجرد كلمة والسلام، حيث لا توجد علاقة بين ما يتضمنه ذلك البرنامج، وما يعيشه أو يحتاجه الشرق الأوسط. والمثل الآخر يجسده مشروع مقترح لوحدة "للدراسات العربية" في إحدى المؤسسات الأكاديمية العربية. وكأي كلمة يوحي هذا التعبير بتلبية مواصفات بعينها، لكن للصدمة والذهول فإنه يستبعد اللغة العربية. فأي دال وأي مدلول هذا؟ وسوف أعود بعد قليل لأقدم أمثلة أخرى لإنتاج اللا معنى، ولتلك العدمية الفكرية التي أنستنا طبيعة وهوية ورسالة العلوم الاجتماعية. لكن ما هو أصلاً المعنى الذي يجب أن تركز عليه العلوم الاجتماعية وما هي هوية ورسالة تلك العلوم؟
للإجابة على هذا السؤال أعود إلى نص موجز لكنه عميق للعبقري السوري عبدالرحمن الكواكبي يلخص المعنى الأسمى للعلوم الاجتماعية وهو مقاومة القهر، كل أشكال القهر. يقول الكواكبي في صفحتي 46 و47 من كتابه الأيقوني "طبائع الاستبداد":
"إن الاستبداد لا يخشى علوم اللغة، فتلك العلوم التي بعضها يقوّم اللسان أكثرها هزل وهذيان. وهو لا يخاف علوم اللغة إلا إذا كان وراء اللسان حكمة.. وكذلك لا يخاف الاستبداد من العلوم الدينية المتعلقة بما بين الإنسان وربه، لأنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة وإنما يتلهى بها المتهوسون حتى إذا أضاعوا فيها أعمارهم وصاروا لا يرون علماً غير علمهم، أمن الاستبداد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خمر. لكن فرائص الاستبداد ترتعد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع والسياسة المدنية والتاريخ المفصل والخطابة الأدبية ونحو ذلك من العلوم التي تكبّر النفس وتوسع العقول وتعرف الإنسان حقوقه وكم هو مغبون فيها وكيف الطلب وكيف النوال وكيف الحفظ."
هذا هو المعنى الذي كان يجب وما زال يجب على كليات العلوم الاجتماعية العربية أن تنتجه. أن تكون علوم حياة وليس كما هي اليوم علوم ميتة أو شبه ميتة. أن يستعملها الناس في حياتهم لا أن يتركوها جانباً. أن تصل إليهم بسهولة، وتقترب منهم بيسر بلغة يستوعبونها وبطرق مختارة بعناية تكلمهم على قدر أفهامهم. أن تُكبَر نفوسهم، وتوسع عقولهم وتُعرّف الإنسان حقوقه وكم هو مغبون فيها وكيف يطلبها وكيف ينالها وكيف يحافظ عليها. لكن حال العلوم الاجتماعية العربية بعيد عن ذلك، لأنها دخلت في متاهة لا تبدو لها نهاية تمزقها بين مجموعة من الأصول الفلسفية الراسخ،ة وكثير من الممارسات الماسخة التي لا يمكن أن ينتج عنها شيء سوى اللا معنى. وسأكتفي برصد خمس ملامح لتلك المتاهة.
أولاً: العلوم الاجتماعية الراسخة ذات المعنى علوم انتماء، لأنها ببساطة شديدة علوم دولة، أو للدقة علوم وطنية، مهمتها حماية الوطن والارتقاء بالمواطن والانطلاق بالمقام الأول من ثم العودة في المقام الأخير إلى كل ما هو محلي. علوم مهما اختلط دارسوها بالعالم وامتزجوا بأفكاره وتعرفوا على ما فيه، تبقى مهمتها الرئيسية منصبة على بناء وعي وطني محلي بالذات، عميق ومؤصل يتناقله الناس جيلاً تلو جيل. أما ما يحدث في كثير من الممارسات العربية للعلوم الاجتماعية، فأمر ماسخ على أقل تقدير. فقد بات مشتغلون كثر بتلك العلوم في المنطقة يستوردون كل شيء من الخارج ولا يفكرون في تطويره من الداخل، بدءًا من النظريات العلمية والأمثلة التطبيقية، إلى الكتب المدرسية والمناهج الدراسية إلى توصيف المقررات وقائمة موضوعات البحوث، وصولاً إلى لغة التعليم ذاتها. ويزيد المسخ بلة ذلك اللهاث العجيب وراء الاعتمادات الأكاديمية الأجنبية ومعايير الأداء المقتبسة واستجداء الظهور في قوائم التصنيف الكبرى، التي تتحكم فيها جهات نفعية تقبع وراء البحار، ناهيك عن استيراد عمالة فكرية أجنبية، قسم منها غير قادر على فهم الإشكاليات المحلية والتصدي للقضايا الوطنية. وعندما تتسبب ممارسة العلوم الاجتماعية في مثل هذه الصور من الإيذاء فإنها تصبح علوماً بلا معنى.
ثانياً: العلوم الاجتماعية الراسخة علوم مجتمع، واجبها أن تتحداه وتستنهض تفكيره. لكن ليس من حقها أن تتجرأ عليه لتستعديه وتسخفه، وإلا فعليها السلامة. فالناس أذكياء. يراقبون كل شيء ويتابعون كل شخص، بما في ذلك المشتغلين بالعلوم الاجتماعية، ويتحسسون بشدة لما يترامى إليهم إن هدد ثوابتهم وخالف توقعاتهم. وأبسط رد فعل يصدر عنهم عندما يجدون العلوم الاجتماعية تهدد حياة أولادهم أن يصفوها باللا معنى. فهم لا يرسلون أبناءهم لدراسة تلك العلوم إلا لصورة مسبقة لديهم تفترض أنها علوم صديقة لثقافتهم أمينة على ثوابتهم. فإن تبين لهم أنها تشكك فيها انصرفوا عنها وأغلقوا صفحتها. كما ينتظر الناس من العلوم الاجتماعية أن تقدم لهم حلولاً تشبههم بمرجعيات تناسبهم، وليس حلولاً بمرجعيات مستعارة تنقل بالكربون من الخارج البعيد، قبل أن تهتم أولاً بالفهم الصبور للداخل القريب. لكن ممارسات عديد من كليات العلوم الاجتماعية العربية تشير إلى عكس ذلك. تشير إلى أنها بنت وعياً زائفاً لما استسلمت للإمبريالية المعرفية، فدخلت في غيبوبة فصلتها عن مجتمعاتها وجعلتها تسرف في إنتاج اللا معنى.
ثالثاً: العلوم الاجتماعية الراسخة ذات المعنى تنتج ما يلفت انتباه صناع القرار، وما يفهمه الناس بأبجدية يعرفونها وليس بلغات دخيلة عليهم. صناع القرار لا يحبون التقعير ولا وقت لديهم للتنظير وطبيعة مهامهم عملية للغاية، وهي أمور لا يتدرب عليها معظم المشتغلين بالعلوم الاجتماعية العربية. أما عامة الناس، فالمدخل إليهم لن يكون إلا عبر آذانهم. ولهذا تهمهم مسألة اللغة. ومسألة اللغة جد خطيرة وجد مهمة لا يمكن التعامل معها باستخفاف، أو تصويرها على أنها مجرد تدفق لذبذبات نغمية تربط من يتكلم بمن يسمع، لأن اللغة ليست مجرد وسيلة اتصال، وإنما مخزن كامل للوعي. وبما أن الوعي هو صناعة العلوم الاجتماعية، فإن تغييب اللغة العربية تماماً في بعض كليات العلوم الاجتماعية وتهميشها في أخرى، أنتج وعياً زائفاً وأفرز كثيراً من التشوهات، بل واللا معنى، خاصةً وأن ذلك التهميش يجري تبريره بحجة يعتقد من يستعملها أنه يفحم مستمعيه وهي اللحاق بالمتقدمين. وتلك قمة اللا معنى. فمن يدفعه تعلم العلوم الاجتماعية إلى الخجل من لغته سيخجل تباعاً من ثقافته، ثم من هويته وكينونته ليصبح هو والعدم سواء.
رابعاً: العلوم الاجتماعية الراسخة ذات المعنى علوم ناطقة، جريئة وشجاعة لا مكان فيها للجبناء والصامتين والمتوارين والمتخاذلين ممن يلتزمون الحيطة بهوس، والسكوت بشكل مرضي. هي علوم رأي وقيم لا يمكن للمشتغلين فيها أن يعيشوا حياتهم بلا لون أو طعم أو رائحة. لكن في نفس الوقت، وبرغم الحاجة إلى الشجاعة والإقدام، لا ينبغي أن تنقلب كليات العلوم الاجتماعية إلى ساحات يرعى فيها الحمقى والمتهورون. هي علوم تحتاج إلى الشجاعة الممزوجة بالمسؤولية، والمواقف الصريحة المقرونة بالاتزان، والاتجاهات المعلنة شريطة أن تكون منطقية. وهذه الشجاعة والصراحة والجرأة ليست عيوباً في ممارسة تلك العلوم، بل إن ذلك هو طبعها. فهي علوم لا تحتمل التقية أو سد الفم، لأن التقية والسكوت فيها خيانة لا تنتج شيئاً إلا اللا معنى. وأستدعي هنا ذلك المصطلح البديع الذي يستعمله أخوتنا الكرام في السودان عن"الكلام الساكت"، ذلك الكلام الذي يتواصل ويتدفق دون أن يكون له معنى أو قيمة أو مدلول. كلام يستطيع من يتقن تفانينه أن يتفاصح ويتحذلق دون أن يُفهم منه شيئاً. وهذا الكلام الساكت لا ترضى عنه العلوم الاجتماعية الراسخة أبداً. أما الممارسات الماسخة فتعشق الكلام الساكت العقيم عديم المعنى.
العلوم الاجتماعية الراسخة ذات المعنى علوم جسارة وحجة، تشترط فيمن يرغب في العمل بها أن يفصح عن رأيه وأن يكون له موقف، وألا يكتفي بالفرجة أو أن يعيش بطريقة wait and see، أو أنا وبعدي الطوفان أو "معاهم معاهم عليهم عليهم،" وإلا لأصبح ببساطة مشتغلا لكنه غير منتم. فالاشتغال بالعلوم الاجتماعية ليس وظيفة وإنما مهمة. والمشتغل بها ليس موظفاً كل ما يعنيه أن يستوفي شروط الترقية وينقذ لقمة العيش. فهذه أمور فردية مهمة، لكنها لا يمكن أن تعطي للعلوم الاجتماعية معنى، ومن يركز بالكامل عليها يدخل، برغم حسن نواياه أحياناً، في دائرة اللا منتمين.
خامسَا: تبدأ العلوم الاجتماعية الراسخة ذات المعنى من الفلسفة وتنتهي بها وإليها. لكن ما حدث بالتدريج عبر عقود في عديد من كليات العلوم الاجتماعية العربية، ثم تسارع في السنوات الأخيرة أنها راحت تحت ضغط التبعية والتقليد وبمزاعم اللحاق والتجديد تنصرف عن الأصول الفلسفية لتنشغل بالأدوات على حساب الغايات، ولتعتني بما أسميه مجازاً "ميكانيكا العلوم الاجتماعية" على حساب جوهرها القيمي الخالص أو ما أسميه بـ"استاتيكا العلوم الاجتماعية". نسيت الإنسان لتنشغل بالآلة. ومصيبة العلوم الاجتماعية العربية في هذا الصدد أن مسيرها يختلف عن مسار العلوم الاجتماعية الغربية التي تحاول أن تقلدها وتتشبه بها. فعلى عكس العلوم الاجتماعية الغربية، لم تصل العلوم الاجتماعية العربية بعد إلى غايتها، ولم تقدم شيئاً يذكر يساعد الإنسان، كما ذهب الكواكبي، على تكبير نفسه وتوسيع عقله وطلب ونيل وحفظ حقوقه، بل تخلت عن هذا كله وراحت تعطي مساحات متزايدة للأدوات والتقنيات لتعتني بالحوسبة والرقمنة والمنصات المعملية وبرمجيات التذاكي المصطنع والنماذج اللغوية الكبيرة، وغير ذلك من مظاهر الأتمتة التي تنذر بتحول عدد كبير من المشتغلين بها إلى ميكانيكيّ آلات ومجمعي أرقام وصناع قوالب، يركزون على مكملات المكياج العلمي لتضيع الجذور الفلسفية للعلم الاجتماعي وتضيع معها عملية انتاج المعنى. فكل هذه الأدوات الجديدة مهمة بلا شك لكن بدون تأطيرها فلسفياً ستتحول إلى أدوات عديمة القيمة لا تنتج غير اللا معنى.
ومثلما جرى قذف المجتمعات العربية بسرعة وقسوة إلى ما بعد الحداثة دون أن تمر على مهل بالحداثة حتى تفهمها وتهضمها، يجري قذف العلوم الاجتماعية العربية حالياً بطريقة ركيكة غير مدروسة فلسفياً إلى تطبيقات ما بعد الحداثة، ليس فقط دون أن تستوعب الحداثة أولاً، بل وحتى دون أن تتخلص من البداوة المعرفية وضيق الأفق المروع الذي ما زال مسيطراً على طريقة تفكير قطاعات ليست قليلة من المشتغلين العرب بتلك العلوم. وكل ذلك يغرقها في انتاج اللا معنى.
هذه الصور الخمس مجتمعة تعيدنا إلى مشكلة الانفصال بين الدال والمدلول. فعندما تختلف الصفة عن الموصوف، والاسم عن الفعل، والدال عن المدلول، واللفظ عن المعنى، وكليات العلوم الاجتماعية عن رسالة العلوم الاجتماعية إلا ويضطرب وجود تلك الكليات، بل ويصبح بعضها والعدم سواء. فلا معنى للشيء إذا فقد جوهره وهويته ورسالته. وهذا ما حدث بأسف وأسى كبيرين في حقل الإنسانيات والعلوم الاجتماعية العربية. فبدلاً من أن تقوم مؤسساتها بشرح وتوضيح ونقد وتصحيح المعني، راح بعضها يهذي وينتج، بل ويعيد إنتاج اللا معنى. ولا بد من التماس بعض العذر لتلك المؤسسات، لأنها في نهاية الأمر ليست إلا جزءًا صغيراً من مجتمع أكبر ينتج بدوره كل يوم كثيراً من اللا معنى. فلدينا مجتمعات عربية ينادي الناس فيها السباك مثلاً بالدكتور، ويسمون ميكانيكي السيارات بالباشمهندس، والضابط بالباشا، والمشاغبين بالنشطاء، ومثيري الفتن بالمؤثرين وناشري التفاهة بصناع المحتوى، ويجاملون العاطل فيسمونه self-employed، والحبل هكذا على الجرار في فصل الدال عن المدلول وقتل المعنى، ليسمى الانقلاب ثورة والقهر حرية والديكتاتورية مشاركة والسرقة إعادة هيكلة والاحتكار خصخصة والتغريب حداثة. (يتبع).
---------------------------
بقلم: د. إبراهيم عرفات
(الجزء الأول من ورقة بعنوان: العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية بين تغليب اللا منتمين وتغييب المعنى - دردشة مع الذات)